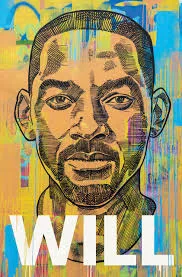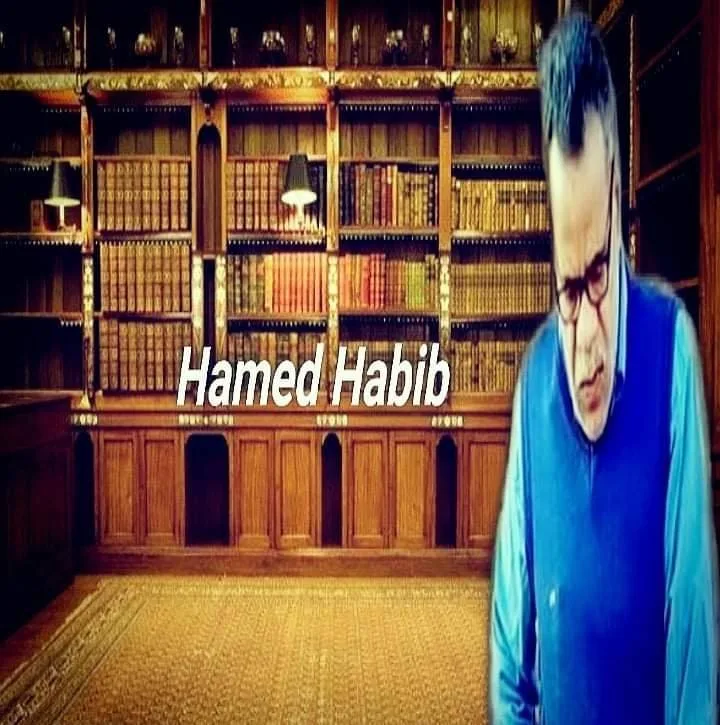الأرجوحة الحمراء …./. قصة قصيرة
ليلى عبدالواحد المرّاني / العراق
ترجمة: سمية الإسماعيل /سورية
احتضنتْ دبّ (الپاندا) الذي تضعه قرب وسادتها منذ عشرين عاماً، قبّلته، وفِي أذنه وشوشت، “أنت صديقي منذ الأزل، أعرفك وتعرفني، أسراري كلها معك.. مطمئنّةٌ أنا، ليس لأنك لا تنطق، ولكن العِشرة بيننا جعلت منّا صديقين بل وأكثر، ضاقت أنفاسي في صدري، وأريد أن أسرّك بأمر يعذّبني”.
نظرت في عينيه اللتين بالكاد تظهران غائرتين بكثافة فروٍ أبيض، وهالتان سوداوان تحيطان بهما. أحسّت به ينظر إليها مستفهما، أردفت، ” أنا واحدة من طابور نساءٍ يطلق عليهنّ عوانس، هل تعرف معنى ذلك؟ بالتأكيد لا تعرف، سأقول لك.. يقولون فاتها القطار، لأوضّح أكثر، من لا تتزوّج يطلقون عليها جوراً لقب العانس، أبيحك سرّاً الآن وأدري أنك ستحتفظ به في حنايا قلبك الصغير، أنا لست عانسا كما يتوقعون”.
اقتربت منه توشوشه، “لقد تزوجت” ابتسمت وأنار وجهها.. “نعم.. لقد تزوجت عدّة مرات، هم لا يعلمون، ولا يهمّني أن أخبرهم. أنا يا صديقي أخوض كلّ أسبوع تجربة زواج.. زواج فاشل، أخرج منها نادمة، وأقسم ألاّ أعيدها.. ورغماً عني أقع في فخّ الزواج ثانيةً، وثالثة، ورابعة.. والعدد مفتوحٌ .. إحدى زيجاتي، حين كنت في الجامعة. أستاذي البريطاني ، شابّ وسيم وأنيق، تتهافت الطالبات عليه، أنا الوحيدة من أثارت انتباهه.. تحمرّ وجنتاه خجلاً، وهو يستشعر لهيب نظرات الفتيات تصوّب نحوه.. أضحك في سرّي جذلى، أعرف أني أنا فقط من ينبض قلبه لها.
ألتقيه في المعهد البريطاني، نشرب القهوة معاً، معي في أحلامي ليالٍ كثيرة، وفِي يقظتي أعيش معه كلّ لحظةٍ بحبّ واشتياق. أباح لي بحبّه، طرت فرحاً إلى سابع سماء، وددت لو أرتمي على صدره، وأغرق في بحر حبّه. قصتنا أصبحت تتناقلها الأفواه، زادني ذلك غروراً، ونظرات الحسد والغيرة تكاد تُمزِّقني، أنا وحدي، وحدي أنا من استطاعت أن تستولي على قلبه، ذلك الوسيم الخجول، القادم من بلد الضباب..
كي أكون متفوّقةً يفخر بي، بذلت جهداً مضاعفاً في السنة النهائيّة، وتخرّجت بدرجة امتياز تؤهلني للحصول على بعثةٍ دراسية. صارحني برغبته في الزواج، وكنت أعلم تماماً أنّ أهلي سيرفضون، بل ربما يناله منهم أذىً، وكان اتفاقاً بيننا أن ألحق به بعد أن انتهى عقده في العمل.. وحدث..
وطفلٌ جميل كإشراقة الشمس، كان وليدنا الأول.. أمنية تراودني مُذ كنت طفلة بأرجوحةٍ حمراء تحلّق بي إلى السماء؛ فأمسك الغيوم.. أبعثرها، وأنثرها عطراً وحبّاً على حقولٍ مترعةٍ بالرياحين.
غامرةً كانت سعادتي وأنا مع زوجٍ أعشقه، وطفلٍ يكاد يطابقه شكلاً وملامحَ.. وأرجوحةٌ حمراء في حديقتنا الصغيرة، تطير بملاكي الصغير، فيكركر، وتحمرّ وجنتاه كأبيه؛ فتغمر السعادة قلبي وروحي..
كابوساً ما حدث ذلك اليوم .. لا يزال جسمي يرتجف حين أتذكّره، وما زالت الصورة بشعةً ومقزّزةً، تجعلني أتقيّأ حين أستحضرها. في غرفة نومنا، وعلى فراشنا المشترك، صعقت وأنا أراه عارياً بين أحضان كهلٍ عملاق. كنت في مشوارٍ صباحي خارج البيت، عدت وطفلي معي أحمل له باقة الورد التي يحبّ.. فاجأته، لم يكن ينتظر عودتي.. لم أعد أذكر ماذا فعلت حينها.. هل صرختُ؟.. بكيتُ؟.. هل حطّمتُ ما كان أمامي فوق رأسيهما؟.. هل أغمي عليّ؟ وهل.. وهل؟ ما أذكره أنني أخذت طفلي وهرعت أعدو في الشارع.. مجنونةً كنت، أبكي وأَلْعَن، ثم أضحك بهستيريا حاضنةً طفلي حتى كدت أخنقه.
تلقّفتني صديقتي، بكيت على صدرها وأنا أهلوس، ” أريد أن أعود إلى بلدي، إلى أهلي، أريد أن أعود “
بلّل دمعها فروة الدبّ الأبيض.. تراءت لها دموعه هو الآخر تنهمر، احتضنته، ” آسفة عزيزي أثرت حزنك، مضطرّة أقصّ عليك، فأنت الوحيد الذي يسمعني بصمت، ويصدّق ما أقول عن كل زيجة لي من بين العشرات “
ابتلعت ريقها المرّ واحتضنت دبها بحرارة، ” زواجٍ آخر سأحكي لك عنه.. رضخت لضغوطات أهلي، رغم عدم قناعتي، وتزوّجته بعد تقريع وقرص بالكلمات.. ” سيفوتك القطار.. عانساً تصبحين.. صديقاتك وقريباتك أصبحنَ رفيقاتٍ لأولادهنَّ، وأنتِ.. ” وتزمّ والدتي شفتيها بسخرية مؤلمة، ويرمقني والدي الصامت أبداً بنظرةٍ حارقة تخترق روحي؛ فأبكي..
شبه معدمٍ، ولكنه ثريّ بشعاراته ومبادئه، وكتبه المزروعة في كلّ ركنٍ من بيتنا الصغير.. حياةٌ روتينيّة، تكاد تكون بائسة، وضيق يدٍ يخنق كلّ طموحاتي وأحلامي، وأكثرها إيلاماً، حلمٌ لم يتحقّق إلاّ بعد أربع سنوات.. طفلٌ وأرجوحةٌ حمراء صغيرة، وفَّرت ثمنها من مصروف لا يكاد يسدّ حاجتنا.
صغيرٌ طفلي، كبرعمٍ لم يتفتّح.. من روحي ومن دم شراييني أرضعته حليباً لم يكن ثديي يدرّ به. يوماً فيوماً أتأمّله، أستعجله أن يكبر.. أن يملأ عيني، فقد كان صغيراً كعصفورٍ خرج للتوّ من بيضته.
أملٌ يرقص في صدري أن أراه يوماً يطير فرحاً والأرجوحة الحمراء تحلّق به، فيمسك الغيوم وينثرها حبّاً على وجهي..
وحدي أحلم، ووحدي أترقّب اليوم الذي أحمل فيه صغيري، وأضعه في أرجوحته الحمراء، وأبٌ قابعٌ في مكتبه بين أكداس الكتب والأوراق المبعثرة.. ماذا يكتب؟ ولمن، ومع من يتحدّث؟ أسئلةٌ كثيرة تثير استغرابي، لكنّ نظرة إلى وجه طفلي الصغير تنسيني كلّ تساؤلاتي؛ فأضمّه إلى صدري، وأقبّل وجهه الملائكي.
وكما يصعقك مسٌّ كهربائي، صُعقنا والباب يطرق بعنف وجنون بعد منتصف الليل، أسرعتُ حاملةً صغيري ملتصقاً بصدري.. غلاظٌ، متجهّمو الوجوه، ونظرات كالرصاص صُوّبت نحوي وطفلي؛ فازدادت يدايَ عنفاً تضمّه إلى صدري.. ” أين هو؟ “.. ” من؟ “.. ” زوجك “.. وقبل أن أجيب، اخترقوا الصمت وحرمة البيت، واقتادوه إلى عربةٍ دون أرقامٍ وسط ذهولي وبكاء صغيري. مددت يدي لأمسك به، ضربةٌ قويّة على خاصرتي بأخمص البندقيّة ألقتني أرضاً.. وتدحرج ابني من بين يديّ.
عدتُ ثانيةً إلى أهلي باكية مكسورة، أحمل هموم طفلٍ يكاد يكون يتيماً، وضياع زوجٍ أحسبه دوما في عداد المفقودين، غصَّةٌ لا تزال تثقل صدري.. تركت الأرجوحة الحمراء هناك، فبيت أهلي كعلبة كبريت لا مكان عندهم لأرجوحة طفلي”
احتضنت دبّها الصغير معانِقةً، تهمس في أذنه: “طفلي الجميل، غدا سأقصّ عليك قصتي مع أبيك.. يبدو أنك نمت”
قبّلته برفق وسارت الهوينى تضعه في الأرجوحة الحمراء، شاردةً جلست تنسج خيالات قصصٍ لأزواج جدد …